وداعاً يا ذكرين
وداعاً يا ذكرين
رواية للكاتب الفلسطيني، ابن بلدة ذكرين، رشاد ابوشاور (دار الآداب، بيروت 2016)
هي سيرة قرية فلسطينية عاش أهلها مسار الأحداث في فلسطين (الكتاب الأول) وفي اللجوء – الضفة الغربية تحت الحكم الأردني (الكتاب الثاني). تبدأ الرواية عند عودة بعض الشباب (مرشد وحرب) المجندين في الجيش العثماني الى قريتهم وتنتهي عند حل وزارة سليمان باشا النابلسي في الأردن وكافة الأحزاب السياسية في 1957. من خلال سيرة أهل قرية زكرين في قضاء الخليل، يروي الكاتب حياتهم أيام الاحتلال البريطاني وبداية الاستيطان الصهيوني على أراضي القرى الفلسطينية، ثم أحداث ثورة 1936 والدفاع عن القرية عام 1948، قبل الاقتلاع واللجوء. في الكتاب الثاني، يصف المؤلف حياة اللجوء في مخيمات الضفة الغربية، مخيم “الدهيشة” قرب بيت لحم والخضر، ثم مخيم “النويعمة” في أريحا، حيث انتقلت العائلة، هربا من البرد القارص.
يسرد المؤلف سيرة أبيه محمود، منذ ولادته في القرية، ومشاركته باكرا في ثورة 1936 وانخراطه في عصبة التحرر الوطني الشيوعية قبل النكبة، ونشاطه الحزبي في مخيمات اللجوء ضمن الحزب الشيوعي الأردني، واعتقالة وتعذيبه على يد الأجهزة الأردنية، الى رحيله الى دمشق، على أثر الانقلاب في الاردن. تمتاز الرواية في جزئيها بأنها نقلت الكثير من المشاهد والأحداث التي وقعت فعليا خلال هذه الفترة، من خلال شخصياتها وطباعها ومزاجها، وانفعالاتها إزاء ما عايشته، ونمط الحياة في القرية الفلسطينية قبل الاقتلاع، وانتاجها الزراعي والحيواني، وعلاقات أهلها بعضهم ببعض، في داخل القرية ومع القرى الأخرى في المنطقة، وفي مخيمات اللجوء : كيف كان تقسيم المنازل ؟ ما هي المضافة ؟ ما هي أنواع أشجار التين التي زرعت في حقول القرية ؟ كم من الوقت يحتاج أهلها للذهاب الى بيت جبرين القريبة ومدينة الخليل، أو الى القدس ويافا ؟ ولأي سبب ينتقل أهل زكرين الى المدن ؟ متى دخل “الأوتومبيل” الى القرية ؟ ومتى تم افتتاح أول مدرسة ؟ كيف كانت تتخذ القرارات المهمة المتعلقة بمصير القرية أم بإحدى حمولاتها ؟ ما هي الأفكار السياسية التي كانت متداولة في الفترتين (قبل وبعد الاقتلاع – النكبة ؟) وفيما يخص سنوات اللجوء، كيف كانت العلاقة مع الجوار، أهل بيت لحم وفلاحي الخضر ؟ وبعد تشتت العائلات بين المخميات، كيف تأقلمت مع “جيرانها” من القرى الأخرى ؟ كيف كانت المنشورات الحزبية توزّع في المخيمات ؟ كيف يتم توظيف اللاجئ في وكالة الغوث ؟ كيف كانت المعاملة في السجون الأردنية في تلك الفترة ؟ يجيب الكاتب على هذه الأسئلة وغيرها باستخدامه أسلوب الرواية، الذي يساعد الى متابعة الأحداث دون ملل.
تسيطر صورة العم مرشد في الكتاب الأول من الرواية، وهو الفلاح الذي ارتبط بالأرض ورفض الرحيل مفضلا الموت في أرضه (“ربنا أكرمه بموته على أرضه في ذكرين”). فكان يحث أقرباءه، أخاه سلمان وأبناءه بالاهتمام بالأرض والزراعة : “لا بد أن تحب الأرض لتعتني بها… فلا بد أن تتعود على خدمة الأرض لتخدمك”، فلم يتركها أبدا بعد عودته الى القرية، بل ظل يكافح لتطويرها. تحتل صورة الأب محمود في الجزء الثاني، بحسرته وضياعه بين العمل الفدائي والمطلبي بعد الاقتلاع، في حين كان قد شارك في ثورة 1936، ودافع عن القرية عام 1948. وتمثل الخالة مليحة، التي أنقذت العائلة من الجوع، الأم الفلسطينية المثابرة والمكافحة، التي تصدت لكل المصاعب التي واجهها اللاجئون.
تقع قرية زكرين (أو ذكرين) على بعد 27 كلم شمال غربي مدينة الخليل، تم تدمير أغلب بيوتها بعد احتلالها في 22 تشرين أول 1948. لا تبعد القرية كثيرا عن قريتي بيت جبرين والدوايمة، القرية التي اشتهرت بالمجزرة المروّعة التي ارتكبها الصهاينة بحق أهلها عام 1948. استحضر الأنكليز بعد احتلالهم فلسطين المستوطنين اليهود الى القرية وأعطوهم مساحة من أرضها المشاع، على أساس أن هؤلاء “المساكين” هربوا من الحرب في أوروبا، ومكوثهم في القرية مؤقت لحين تنتهي الحرب. بهذه الكلمات، حاول الأنكليز إقناع أهل القرية بوجوب إكرام “الضيوف” وعدم محاربتهم : “أحضرهم الأنكليز وقالوا : هم ضيوف، تحملّوهم، فهم سيعودون من حيث أتوا…”. لم تقم أي علاقة بين المستوطنة الصهيونية وأهل القرية، وفقا للرواية، عكس ما جاء في شهادات عن قرى أخرى، حيث كان الفلاحون، قبل اندلاع ثورة 1936، يبيعون انتجاهم الزراعي الى المستوطنين. في 1948، هجم المستوطنون المسلحون على قرية زكرين وذبحوا اسماعيل وأهله. فدبّ “الخوف في نفوسنا”، إلا أن القرية لم تستسلم. فتم إخلاء العائلات الى كهوف بيت جبرين وبقي الرجال يدافعون عن القرية حتى آخر طلقة، بعد سقوط الساحل بيد المغتصبين، وإثر سقوط بعض قرى الخليل المجاورة.
لم تكن العلاقة مباشرة مع الحكم البريطاني في القرى الفلسطينية، كقرية زكرين، إلا عندما اندلعت الثورة عام 1936 الموجهة ضده حيث شارك فيها شباب قرى الخليل. ولكن أدرك الفلسطينيون “أن هم الأنكليز أصل البلى”، منذ الزيارة التي قام بها وفد من الجيش الى القرية لدراسة مجال الاستيطان فيها، وعدم احترام أهلها : “ها هم يجلسون على فراشنا بأحذيتهم وبكرة سيجلسون على صدورنا” يستنتج مختار زكرين بعد رحيل الوفد. أما الصدام الأول الذي وقع بين أحد أفراد القرية والحكم البريطاني فكان حول “شرب التتن”، وهو التبغ المحلي الذي منع الانتداب تدخينه لصالح شركة التبغ التابعة له : “”ما دخل الانكليز بأن أشرب تتن؟” تساءل سلمان والد محمود، الذي اضطر الذهاب الى المحكمة في الخليل لتسوية المشكلة.
تطرح الرواية، من بين ما تطرحه من مسائل، مسألة الانتماء السياسي في هذه الفترة المفصلية، حيث انتمى الأب محمود الى “عصبة التحرر الوطني” من خلال استاذ مدرسة القرية علي ، الذي عرّفه على أعضاء الحزب في يافا، والذي نقل له بعد النكبة أن “العصبة” أصبحت في الأردن “الحزب الشيوعي الأردني”. فكان “الفلاح الأمي” ضمن مجموعة مؤلفة من أعضاء يمارسون الطب والتدريس والمحاماة وغيرها من المهن الحرة، غير أنه كان “عقله صاحيا”، كما قال أحد المسؤولين عندما طرحت مسألة موقف الحزب من ضم قطاع غزة الى “اسرائيل” بحجة أن الرئيس جمال عبد الناصر ينتمي الى “الرجعية العربية”. رغم أمّيته، كان يوزع منشورات الحزب في مخيمات اللجوء، ويشارك في المظاهرات التي يدعو الحزب اليها، لا سيما ضد “حلف بغداد” وضد “تزوير الانتخابات” التي شارك بها الحزب، الى جانب أحزاب أخرى كالبعثيين (المناضل بهجت أبو غربية). رغم ميوله الى الكفاح المسلح، الذي لم يحبذه الحزب، ظل وفيا لانتمائه الحزبي، وخاصة بعد اعتقاله بسببه، وقد حسم أمره عندما واجه صديقه الفدائي سليم الدوايمي الذي كان يحثّه على الالتحاق بالفدائيين، قائلا له “أنا شيوعي”. فما كان من الفدائي إلا أن خرج من المنزل (الخيمة) ورحل. كان الأب محمود يتعاطف مع الفدائيين (لقد سلّمهم بارودته الذي حارب بها دفاعا عن قريته في 1948) وينتظر أخبارهم، ومنهم قريبه الفدائي عثمان الذي كان يتسلل الى قرية زكرين ليحارب المستوطنين، وكان قد جلب لأقرباءه بعض من أمتعتهم الشخصية الباقية في القرية، قبل نسف بيوتها، وقبل استشهاده في إحدى المهمات الفدائية داخل الوطن. ينقل الكاتب أقوال الشهيد عثمان، في زيارته الأخيرة لمحمود، حول مضايقة “الحرس الوطني” للفدائيين و”المتسللين”، وملاحقتهم من قبل المخبرين الذين “يندسون بين الناس ويجمعون معلومات عن الذين يتسللون ومن لديهم سلاح”. الى أي مدى كان محمود مقتنعا بالحزب الشيوعي الذي ضحى من أجله ؟ كان بلا شك معجبا، كما يروي الكاتب، بالروح الانضباطية، والعمل السري، والروح الأخوية التي تجمع بين أعضاءه (في السجن، ومساعدته في يافا وفي عمان)، ومشاركة المرأة في صفوفه، وكون الحزب يمثل نخبة متعلّمة في المجتمع (“فالجهل هو عدونا” يقول الاستاذ علي). ولكن يبدو، من خلال صفحات الكتاب، أنه بقي عنصرا لا تعنيه كثيرا تفاصيل الحياة الحزبية والخط السياسي الذي يميّز حزبا عن آخر، فكان يحلم بالعودة الى زكرين ويدرك ما هي القوى التي تمنعه عن ذلك.
تمثل الخالة مليحة المرأة الفلسطينية الصبورة التي وقفت وتحدت الظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء. لقد اعتنت بعائلتها وعائلة أقاربها، وكانت توفر لها مستلزمات الحياة، وتساعد جيرانها وتطفئ نيران الخلافات التي تنشب بين أهل المخيمات بسبب الضيق والحرمان. فكانت تركض من مكان الى آخر، تنتقل شرقا مع عائلتها لجمع السنابل وراء الحصادين، في الصباح الباكر، كي تؤمن “الصنادل” و”بدلات الكاكي” لأطفال العائلة. لقد جمعت الخالة مليحة صفات المرأة الكادحة، والمنتمية الى عائلتها وشعبها.
لا يمكن تقدير عمل المرأة الفلسطينية اللاجئة التي حافظت على مجتمعها دون إعادة القارئ الى ذهنه كيف تم تهجير الفلسطينيين وزجهم في المخيمات، في أواخر عقد الأربعينيات. “كأننا في يوم القيامة” تقول أم محمود، وقد تشتتت العائلات بين المخيمات التي نصبت قرب مدن الضفة الغربية، “فلا أحد يعرف أحد، والجميع تفرقوا وتاهوا”. وقبل انتقالهم الى الخيام، عاشوا بين المطر والبرد والوحل، في كل مكان في الخليل ومدن الضفة الغربية وعلى أبوابها وفي حقولها، تحت الأشجار وفي الكهوف، وقد تركوا كل ما لديهم في بيوتهم، ينتظرون من يدلهم على لقمة أو مأوى : (“أرسلوا أولادكم لأخذ بركة أبينا ابراهيم التي نطبخها من القمح. سدوا جوعكم بالقليل يا ناس” صاح رجل خليلي وقف عند طرف حقل الزيتون). بعد انتقالهم الى الخيام، اضطروا لحفر القنوات حولها لمنع تسرب المطر. “صرنا لاجئين! هكذا صرنا! ننام في الوحل تحت شادر الخيام، ولا نملك رغيف خبز…” ثم شرع “الصليب الأحمر” الى توزيع عليهم بقج تحتوي على “ملابس وأحذية وصابونا وأشياء لا نعرفها”. ومن بين هذه الأشياء، ملابس وأحذية “المدنيات” التي لا تعرفها القرويات قبل هذه الأيام (“وهذا كيف نلبسه في أرجلنا ؟” تسأل إحداها بعد أن أخرجت حذاء بكعب عال). في ظل متاعبهم وضياعهم، لم يفكر اللاجئون إلا بالعودة الى قراهم، وقد تحمّلوا القهر و”البهدلة” وهم على يقين أنهم عائدون، إذ اعتبروا أن هذه الخيام مؤقتة، لحين تنتهي “الحرب”، كما وعد الاحتلال البريطاني أهل زكرين عندما أدخل المستوطنين الصهاينة الى القرية.
منذ أول إيام التشريد، حاول أهل القرى المحتلة في قضاء الخليل العودة الى قراهم. منهم من حاول العودة رافعين الراية البيضاء، إلا أن القناصة من المستوطنين استهدفوا العائدين واستشهد “أبو ابراهيم” وكان عائد الى بيت جبرين. ومنهم من حمل السلاح (سالم الدوايمي ابن الشهيد) وقرر تحرير البلاد والعودة. ولكن من أين السلاح ؟ سأل المترددون. تشير النقاشات التي دارت في تلك الإيام الى وعي الفلسطيني لتواطؤ الأنظمة العربية الذي سلمّوا البلاد الى الصهاينة، والى دورها في إجهاض ثورة 1936، لأن لولا الضغط على أيقافها مقابل وعود كاذبة “لما وصلنا الى ما نحن فيه”، “لو واصلنا الثورة ما ضاعت البلاد”.
هذه هي حكاية أهل ذكرين وغيرهم من أهالي القرى الفلسطينية التي احتلها الصهاينة بمساعدة الجيش البريطاني، وهم الى اليوم يعيشون كلاجئين في الضفة الغربية أو في أماكن أخرى من فلسطين والعالم. وبعد 70 عاما على تشريده، بقي اللاجئ الفلسطيني مصرا على عودته، وأصبح حق العودة الى الديار الأصلية الشعار والبرنامج الذي يجمع حوله كافة شرائح الشعب الفلسطيني، من اللاجئين وغير اللاجئين، باستثناء الأقلية التي تعايشت مع الاحتلال وتحاول إيجاد مكانا لها في ظل وجوده. اليوم، بعد 70 عاما على اقتلاع الشعب الفلسطيني من قراه ومدنه، كما فعل في قرية ذكرين، قامت جماهير قطاع غزة بمسيرة العودة الكبرى، مطالبة بالعودة الى البلاد. وكما فعل المستوطن القناص عام 1948 الذي قتل من حاول العودة، يقتل اليوم قناصو جيش الاحتلال من يحاول الاقتراب من السياج الذي وضعه لحماية مستوطناته. لم يتغيّر المشهد منذ 70 عاما من جهة العدو، الذي يعتبر أن العودة هي بمثابة اعتداء عليه وعلى “أرضه”، ولكن تغيّر المشهد من جهة الفلسطينيين، حيث يُرفع العلم الفلسطيني بدلا من الراية البيضاء، وحيث تزحف الجماهير ضمن برنامج واضح يطالب بتطبيق قرار الأمم المتحدة الخاص بعودة اللاجئين، بدلا من المحاولات الفردية للعودة، وحيث يشكل سلاح المقاومة رادعا يحمي قرار المواجهة، بدلا من حالة الضياع وانعدام السلاح في تلك الفترة. فهي قصة الحراذين التي تضع “عود قوي عصي على الانكسار في فمها بالعرض، بحيث تحرم الأفعى مهما فتحت فهما من ابتلاعها، والمعركة تبدأ على الرأس، وهكذا حين يحمي الحرذون رأسه فهو يحمي جسده” التي رواها الاستاذ علي على تلاميذه، والتي استنتج منها الحكمة التالية : “الضعيف يمكن أن يجد وسيلة مهما كانت بسيطة ليدفع عن نفسه أذى من هو أقوى منه… لنتعلم من الحراذين يا أبنائي
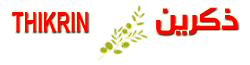
 Previous Post
Previous Post Next Post
Next Post